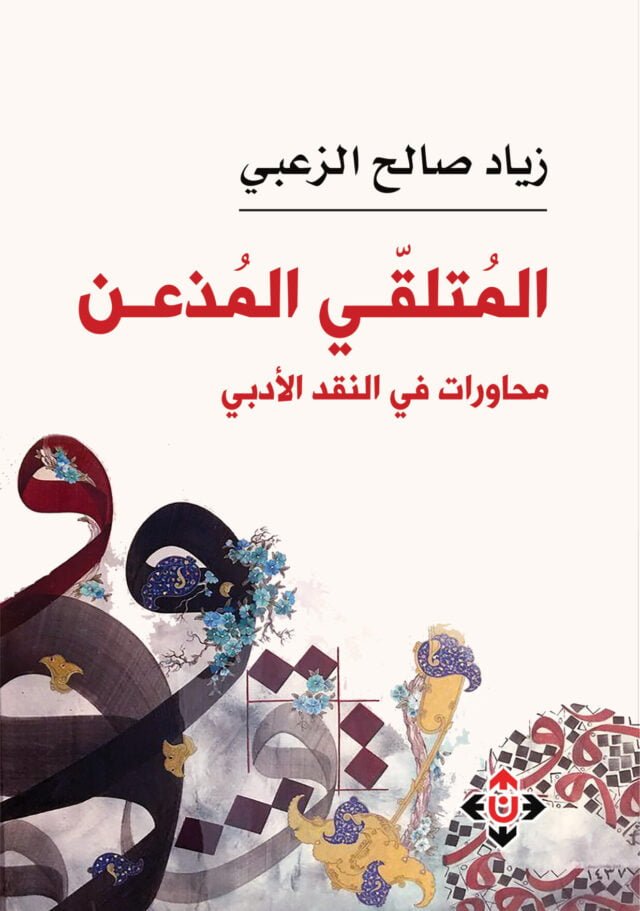class="inline-block portfolio-desc">portfolio
text
معاذ بني عامر
يُمثّل كتاب “المُتلقي المُذعن: محاورات في النقد الأدبي”1 للدكتور “زياد الزعبي”2، بيان إدانة للعقل العالِم في العالَم العربي من زاويتين:
الزاوية الأولى: أخلاقية.
الزاوية الثانية: معرفية.
أخلاقية: ففي الوقت الذي يُعيب فيه العقل العالِم على أتباع العقل الشعبي عدم تمثلهم لقيمة الحرية وافتقادهم لمبدأ السيادة الذاتية الذي يخولهم الحقّ في النظر إلى وجودهم في هذا العالَم على أنه وجود غير أصيل أو وجود بالمعيَّة، وما يترتب على ذلك الوجود المُزيّف من خنوع وخضوع لأنواع مختلفة ومتعددة من العبودية؛ فإنَّ هذا العقل، لا سيما من قبل بعض أتباعه المُنخرطين في النقد الأدبي على نحو مخصوص، يخضع هو الآخر لنوع خطير من العبودية الطوعية3 ألا وهي عبودية الإذعان والقبول التام، على المستويين الذهني والتطبيقي، لأنساق ثقافية قائمة وفاعلة في المجال المعرفي العام دون فحص أو تمحيص لمتونها. فالأَوْلَى بالعقل العالِم، بما هو عقل يستخدم أداة العقل التي واجبها المركزي إعمال ذاتها في مادة العالَم، أن لا يقبل أي شيء كما هو إلا بعد فحصه وتدقيقه وتمحيصه وتبيان صلاحيته للبيئة التي يُنقل إليها؛ بل الأصح والأكثر سلامة وإبداعاً أن لا يقبل أي شيء كما هو بالصيغة التي تَرِد، بل يشرع في إعمال عقله فيما يصل إليه من معارف لكي يتحوَّل هذا العقل من صيغة الانفعال بالوجود4 إلى صيغة الفعل فيه. أما قبول الأشياء كما هي فتلك كارثة مميتة للعقل برمّته، وهذا ما يمكن اعتباره الهدف الأساسي لكتاب (المُتلقي المُذعن)، فهو يسعى إلى “قراءة متسائلة ناقدة لا تستسلم أو تذعن للنصوص وطروحاتها وأفكارها، حتى وإن كانت مما يشيع ويمثل مرجعية يصعب التشكيك فيها أو محاورتها أو نقضها”.5 فهذه القراءة النقدية المُتسائلة التي تجسدت في الكتاب، لم تأتي من فراغ بل من الخلل البالغ والمُعيب في آليات نظر العقل العالِم إلى المعرفة التي يتلقاها، سواء أكانت من تراثه القديم أو من معارف الآخرين، لا سيما ما تعلق منها بالدراسات النقدية الحديثة؛ فهو عقل ناقل ليس إلا، مع كل ما يعتور هذا النقل من إكراهات واستلابات، تصل في كثير من الأحيان إلى درجة الاستلابات الحضارية. أي إنه عقل يفتقد إلى أساسه المعرفي، مع خضوعه لنزعات نفسيه تسلبه حقه في الحرية المعرفية، وتجعل مُصابه مضاعفاً عن مُصاب العقل الشعبي، فهو “ينظر إلى الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيه، ويغضّ الطَّرف عن الخشبة في عينه. و”كيفَ تقدِرُ أن تقولَ لأخيكَ: يا أخي، دَعْني أُخرجُ القَشَّةَ من عينكَ، والخشَبَةُ الّتي في عينكَ أنتَ لا تَراها؟ يا مُرائي، أخرجِ الخشبَةَ من عينكَ أوَّلاً، حتّى تُبصرَ جيِّداً فتُخرجَ القَشَّةَ من عينِ أخيكَ”6
ومعرفية: لناحية عدم تمكُّن المُشتغل بالنقد، في العموم، من أدواته المعرفية كما يجب، ما يندرج تحت التلقي الإذعاني، وهو “تلق لا يحاور النصوص أو يفككها أو ينقضها أو يكشف مصادرها، وهذه فكرة تبين عن بؤس معرفي للتراث الفكري العربي الذي تمت قراءته غالبا قراءة نمطية موضعية عابرة تكتفي بالمتداول الشائع، والمختار الذائع”.7 وما ينطبق على التراث العربي القديم وآليات تعامل النقاد الجُدد معه، ينطبق كذلك على آليات التعامل مع المعرفة الوافدة من الغرب. فما “قاله “دي سوسير” غدا تصورًا مرجعيًّا تقبّله الباحثون في الثقافة الغربية –مع إخضاعه للنقد والتساؤل أحيانًا- وتقبّله واستلمه الباحثون العرب تقبُّلَ إذعان في معظم الأحيان، وذهبوا إلى بناء رؤاهم حول الأسلوبية والبنيوية والسيميائية استنادًا إلى إعجاب وتصديق مطلق لما قرأوا”8
كان “ابن سينا” قد عرَّف الفلسفة بأنها “الوقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليه”.9 ما يجعل من الرؤية التي قدمها “زياد الزعبي” في كتابه (المُتلقي المُذعن) تفضح الموقف الحضاري للأمة العربية في عموميتها. فعقل الأمة، أو أعلى بقعة رمزية في وجودها، عاجز عن أداء الدور المعرفي المنوط به، فهو يقتطع الأشياء اقتطاعاً، ويقطعها عن سياقاتها الأصلية من ثمَّ، مع يجعل رؤيته مشوّهة وقاصرة وغير مكتملة.
ولكي أُطبِّق عملياً التصوُّر السابق، في شقيه الأخلاقي والمعرفي، فإني سآخذ فصل (السيميائية: إشكاليات التنظير ومتاهات التطبيق)، وهو الفصل الثاني من فصول كتاب (المُتلقي المُذعن)؛ والمُتعلق بتلقي الدارسين العرب للمنهج السيميائي باعتباره نقطة مركزية في التطوُّر النقدي، مع عدم إدراك ومعرفة بتأصيلاته في الثقافة العربية القديمة. فقد “اندفع عدد غير قليل من الدارسين العرب نحو هذا العلم الجديد الوافد [يقصد السيمائية] من الغرب، منتج المعرفة، واستقبلوه بحفاوة تليق بزائر غريب دون مساءلة أو محاورة إلى حد بدت معه معظم الكتابات عن السيمياء –حين تجاوز الترجمة- أقرب إلى عرض review للمادة التي يتاح للكاتب الإطلاع عليها؛ وهذا ما أدى إلى ركام من الكتابات التنظيرية المنقولة من المصادر الأوروبية، وإلى محاولات تطبيقية على نصوص أدبية عربية دون أن يفضي هذا إلى إضافة حقيقية أو مغايرة لكثير من القراءات التي اعتمدت تسميات منهجية أخرى”10
فالدارسين العرب تعاملوا مع اللحظة التي خرج فيها المنهج السيميائي كلحظةٍ إيمانية انبثقت من العَدَم إلى الوجود دفعة واحدة، ما جعلهم يَغفلون، بوعي أو بدون وعي، عن اللحظات السابقة التي سبقت تلك اللحظة؛ فليس من نصٍّ معرفي يتأسَّس على العَدَم إلا في عُرف الدراويش والمساكين والمُغفلين. فالأساس أن أي نص ينهل من نصوص سابقة عليه، وكلما كان الكاتب أكثر إبداعاً تمكَّن من صياغة النص الجديد بطريقة مُدهشة تمنحه ميزة فائقة عن غيره من النصوص. هذا التغافل أوقع الدارسين العرب بحرجٍ معرفي كبير، في المقام الأول، فأخذهم نصاً واعتباره مُنبتًّا عمّا قبله يُعتبر مصيبة كبرى تكشف عن عقلية ثيوقراطية تُؤمن باللحظات القصوى والصوابيات المُطلقة، وذلك شيء مُناقض لأبسط قواعد التفكير العلمي. فالمنهج السيميائي لم يكن معزولاً عن سياق الثقافة العربية القديمة، لكن العتاد المعرفي للباحث العربي كان ناقصاً، كما جعله غير مُطلّع على الجذر التكويني لذلك المنهج، أو على الأقل على السياقات المعرفية القديمة التي حظي بها هذا المسلك في ثقافته الأم. فقد “استعملت الأدبيات العربية القديمة على نحو واسع صيغ: سيما، وسيميا، وسيمياء، وسيماء، إضافة إلى استعمال صيغتي: مسوم ومسومين بالبناء والفاعلية والمفعولية. ويرد في المصادر العربية تعريف السيمياء بعلم العلامات، وهو ما نجده حرفيا في الفتوحات المكية لابن عربي، وتفسير القرطبي. ويرد كذلك تعريف السمة بالعلامة في المعاجم، وكتب الأدب، والتفسير وغيرها. وهذا يعني أن العربية تملك مقابلا ليس لمصطلح السيمياء حسب، بل لعلم السيمياء، والحديث هنا يدور على المصطلح، وهو ما يتضح حين نمعن النظر في قراءة النصوص العربية التي تتحدث عن السيمياء مصطلحت ومفهوما في غير حقل من الحقول المعرفية، والاجتماعية، والنفسية، والطبية”11 فقد ضمّت العديد من الكتب التراثية مثل كتاب (القانون) لابن سينا وكتاب (البصائر والذخائر) للتوحيدي و(طوق الحمامة) لابن حزم وكتاب (تزيين الأسواق) للأنطاكي… وغيرها الكثير؛ قراءات للعلامات المتعلقة بجوانب مختلفة من الحياة، “كالجانب النفسي والفيسيولوجي والأزياء والملابس ودلالالتها التواصيلة والثقافية”12
هذا الجذر المعرفي القديم والعميق غاب، كما بيَّن زياد الزعبي، عن “معظم الدراسات العربية الحديثة التي عالجت السيميائيات”13، وهو ما يُشكّل فضيحة معرفية، ينبغي أن لا يقع فيها أتباع العقل العالِم. فالباحث أو الدارس، في هذا المقام، لم يجتهد معرفياً بما فيه الكفاية، بما يجعل من نتائجه التي يتوصل إليها نتائج أكثر انسجاماً مع الرُّوح المعرفية المُفضية إلى الحقيقة. ولأنَّ الباحثين العرب لم يجتهدوا بما فيه الكفاية، فقد وقعوا، في المقام الأول كما أسلفت، في حرج معرفي كبير. وفي المقام الثاني وقعوا في مُحارجة أخلاقية، لأنهم سلموا تسليماً إيمانياً بالنموذج المعرفي للسيميائية كما وردهم عن طريق “دي سوسير”، فأخذوه كما هو دون نقد أو تفكيك أو مراجعة جذرية، ما أوقعهم في عبودية ضمنية، إذ سلموا أن ما يقوله عقل “دي سوسير” يمكن أن يكون معصوماً بشكلٍ مبدئي، وهذا شيء يرفضه السؤال المعرفي رفضاً قاطعاً منذ اللحظة الأولى، لأنه يتعامل مع المعرفة على أنها نسق هُوياتي مُكتمل. لكن، ربما أن تلك أحد مآزق العقل العربي بالمُطْلَق، لناحية أنه يُقدِّم النسق الهُوياتي، سواء أكان دينياً أم سياسياً أم معرفياً أم نقدياً، على السؤال المعرفي، ما يُبقيه في دائرة مُغلقة على المستوى الحضاري، فهو يدرو في حلقات مُفرغة ليس إلا.
وهكذا، فإنَّ كتاب (المُتلقي المُذعن: محاورات في النقد الأدبي) لزياد الزعبي، لم يُشكِّل بيان إدانة للعقل العالِم في حقل الدراسات النقدية فحسب، بل يمكن القول إنه كتاب ينطوي على منزع يُدين العقل العربي في مختلف التخصصات، لناحية تقديمه للأنساق الهُوياتية بما هي أنساق (فوق نقدية) أو أنساق إيمانية تُعرض نتائجها قبل مقدماتها، على حساب السؤال المعرفي بما هو سؤال ينتصر للعقل في مواضعاته النقدية، فهو يُعلِّق النتائج، في أي بحث يبحثه، بانتظار فحص المقدمات وتمحيصها وتفكيك أبنيتها.
الهوامش:
1 زياد صالح الزعبي، المُتلقي المُذعن: محاورات في النقد الأدبي، الآن ناشرون وموزعون، عمَّان، الأردن، ط1، 2024.
2 زياد صالح الزعبي، أستاذ النقد الأدبي: الدراسات الأدبية المقارنة، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة اليرموك، إربد، الأردن.
من كتبه المنشورة:
عشيات وادي اليابس، ديوان مصطفى وهبي التل، عرار، دراسة وتحقيق وتقديم.
الثقافة وتحولات المصطلح: دراسات في المصطلحات النقدية والبلاغية.
الشرق والغرب واللقاء المستحيل، الصحائف لأبي الفضل الوليد.
نقلاً عن كتاب (المُتلقي المُذعن: محاورات في النقد الأدبي)، ص ص 157- 158.
3 مصطلح “العبودية الطوعية” هو مصطلح لـ “إيتيان دو لا بويسي”، وهي نوع من الاستسلام الاختياري لبطش الطاغية. وإنْ كان “إيثيان دو لا بويسي” قد تحدَّث في كتابه الذي حمل عنوان مصطلحه عن العبودية السياسية أكثر، إلا أنه مصطلح ولَّاد ويمكن أن ينطبق على أمور كثيرة، بما فيها مسألة العبودية المعرفية، ما يجعل الأمر أكثر إضحاكاً وإيلاماً أيضاً.
يمكن العودة إلى كتاب: مقالة العبودية الطوعية لـ إيتيان دو لا بويسي، ترجمة عبود كاسوحة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2008.
4 الأسوأ من الانفعال بالوجود، هو أن يصل المرء أو الأمة إلى مرحلة المفعول بها من قبل الآخرين، فوجودها، والحالة هذه، وجود مُهين من البناء النفسي إلى السياق الحضاري.
5 المُتلقي المُذعن، مرجع سابق، ص 6.
6 الكتاب المقدس، العهد الجديد، إنجيل لوقا، السِّفر 6، الآية 41، دار الكتاب المقدّس في الشرق الأوسط، بيروت، لبنان، الإصدار الرابع، ط 30، 1993.
والنص الكامل للآية: “لماذا تنظُرُ إلى القَشَّةِ في عين أخيكَ، ولا تُبالي بالخَشَبَةِ في عينكَ؟ وكيفَ تقدِرُ أن تقولَ لأخيكَ: يا أخي، دَعْني أُخرجُ القَشَّةَ من عينكَ، والخشَبَةُ الّتي في عينكَ أنتَ لا تَراها؟ يا مُرائي، أخرجِ الخشبَةَ من عينكَ أوَّلاً، حتّى تُبصرَ جيِّداً فتُخرجَ القَشَّةَ من عينِ أخيكَ”.
7 المُتلقي المُذعن، مرجع سابق، ص 9.
8 المرجع السابق، ص 6.
9 جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج2، مادة فلسفة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1982، ص 160.
10 المُتلقي المُذعن، مرجع سابق، ص ص 36- 37.
11 المرجع السابق، ص ص 38- 39.
12 المرجع السابق، ص 39.
13 المرجع السابق، ص 39.
(معاذ بني عامر، مجلة أفكار الأردنية، العدد 438، تموز 2025).