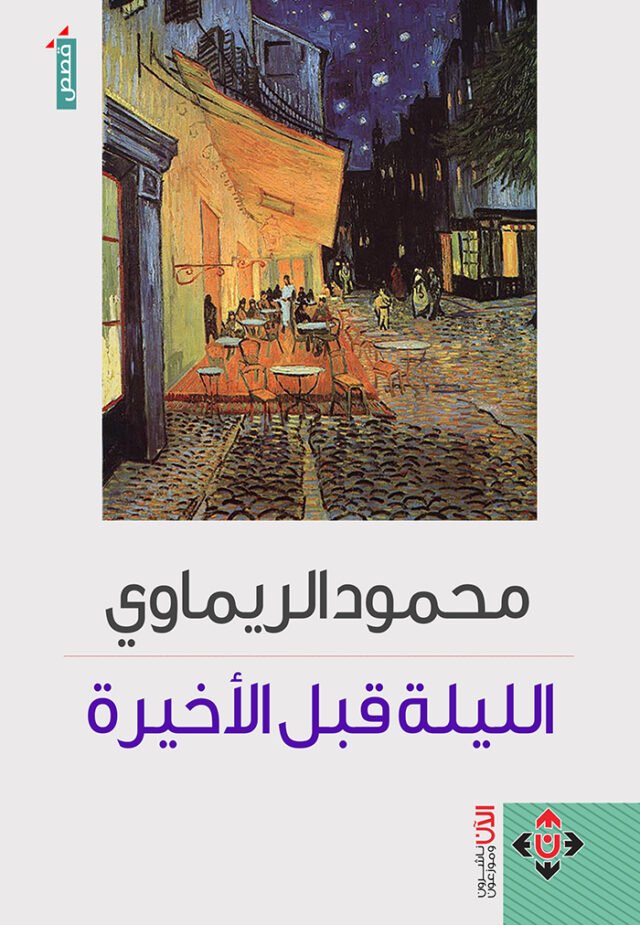class="inline-block portfolio-desc">portfolio
text
إبراهيم خليل
ما يزال القاص محمود الريماوي يواصل عطاءه الإبداعي، الذي لا يغتني بتكرار النماذج والقصص وتراكمها وحسب، بل يضيف جديدا لمشروعه القصصي في كل مجموعة يصدرها، وفي كل كتاب ينشره. فبعد مجموعاته «العري في صحراء ليلية» 1972 و«الجرح الشمالي» 1980 و«كوكب تفاح وأملاح» 1987 و«ضرب بطيء على طبل صغير» 1990 و«غرباء» 1993 و«القطار» 1996 و«شجرة العائلة» 2000 و«الوديعة» 2001 و«رجوع الطائر» 2006 و«فرق التوقيت» 2011 و«عودة عرار» 2013 و«عم تبحث في مراكش» 2015 و«ضيف على العالم» 2017 تصدر له مجموعة جديدة بعنوان «الليلة قبل الأخيرة» (دار الآن، عمان، 2020 ) في اثنتي عشرة قصة وشهادة، كان قد نشرها في الكتاب الموسوم بعنوان «النظر في المرآة» وهو كتاب صدر بمشاركة 30 كاتبا عربيا أعده وحرره صفاء ذياب، وصدر بتقديم عبدالله إبراهيم عن دار شهريار في بغداد 2020.
واللافت للنظر في هذه القصص، أن القاص يقتنص ببصيرة نافذة مواقف نادرة، وطريفة من حياة شخصياته، التي هي في العادة شخصيات من عامة الناس، وليست لديها ملامح خاصة أو مميزة تجعلها شخصيات نموذجية، أو نمطية، تختلف عن سائر الشخوص، إلا من حيث الموقف الطريف الذي يأخذنا إليه الكاتب. ففي قصة «دودي» يظن القارئ – وهو يتنقل فيها من عبارة لأخرى في الحوار الدائر بين المحب الغيور والفتاة التي تبدو من الوهلة الأولى لعوبا – أن العلاقة بين الاثنين تمرّ في أزمة، قد تفضي إلى فراق، بيد أن المؤلف يكسر حدة هذا الظن مخالفا التوقع، بكشف الفتاة للعاشق عن أن دودي هذا ليس رجلا وإنما هو (دبدوب) أهدي إليها، وهي طفلة، وما تزال شديدة التعلق به، في إشارة لعقدة النكوص التي تعاني منها هذه الفتاة، ولذا لا ترى فيمن تحبّ إلا صورة ذلك الدب، الذي ما تزال مفتونة به إلى الآن، مثلما كانت مفتونة به حين أهدي إليها، وقد تطورت هذه (المزحة) إذا ساغ التعبير لتتحول إلى موقف ندّيّ بذكره حكاية الناي.
وفي أثناء القراءة يتوقف القارئ إزاء الحوار الدائر بين الاثنين، متلهفا لمعرفة ما ستؤول إليه مشاعر الغيرة، والمكر، التي طبعت بها تلك اللحظة القصصية من حياة الحبيبين. وهذا يتيح للقارئ التلذذ بالقراءة، متمنيا أن تطول القصة، وأن يستمر في التعرف والاستكشاف.
وهذا الإحساس يكاد لا يفارق القارئ في قراءته لقصة أخرى بعنوان «طبق للغداء وشاي داكن». فالسيدة الأرملة في القصة لا تفتأ منذ رحيل الزوج تشاركه مائدة الغداء كل يوم. فبدلا من أن تملأ طبقا واحدا بالطعام تملأ اثنين واحدا لها والآخر للفقيد، تضع الطبقين، وما يلزمهما من ملاعق وشوك وسكاكين ومقبلات، وتتناول طعامها بأناة وهي تتحدث مع الزوج، وتؤكد له أن هذا هو طبقه المفضل، وقد أعدته له خاصة لأنه يشتهيه أكثر من سواه. وفي اللحظة التي تتذكر فيها الخادمة البنغالية، التي حدثتها هي الأخرى أنها فقدت زوجها منذ زمن طويل في مشاجرة، بدأ نسقٌ جديد يفرض نفسه على القصة، وغدا الطبق الواحد أربعة أطباق، اثنين منها للخادمة، وزوجها الراحل. وتمضي السيدة مستمتعة بهذا الوفاء، في حين أن الأرملة البنغالية تقابل هذه المُجاملة بابتسامة شاحِبَة فاترة.
هذه القصص مع أنها تمثل تراكما جديدا لعطاء الكاتب تضفي في الوقت نفسه لونا آخر على هذا العطاء مزيته السخرية، وخفة الــــروح، والدعابة، مع المزج بين الواقع المتخيل، وتجاوز هذه الواقع إلى الغريب، والعجيب، مما يسبغ على السرد مُتْعة القصّ.
والطريف في هذه القصة تلك التفاصيل التي يرويها السارد عن السيدتين، وعن الغداء، وعن الشاي الداكن، وعن الزوجين الراحلين، وعن الذكرى، فرغم بساطتها، تشد القارئ شدًا كالذي يقع تحت تأثيره في القصة الموسومة بعنوان «سرُّ الأسرار» فالمعلم الخمسيني في القصة، العازب، المتخصص في الرياضيات، الذي يعرف عنه الإفراط في التدخين، يُضطر اضطرارا لزيارة طبيب نفسي للمرة الأولى. أما سبب هذه الزيارة فقد يبدو للقارئ سببا تافها لا يستحق من أجله حتى التفكير بمثل هذه الزيارة، فهو كلما قرأ شيئا عن الأحلام، أو شاهد فيلما يمرّ بطله ببعض الأحلام، أو سمع من يروي شيئا مما تراءى له في منامه، تصيبه غصَّة، وذلك لأنه لا يحلم البتة. صحيح أنه كان قبيل أن يبلغ العشرين يرى فيما يرى النائم أحلامًا، غير أنه أقلع عن ذلك منذ نحو 30 عاما أو أكثر. فهو ينام نوم القتيل.
ويطردُ الحوار بين تصميم المعلم على أنه مريض ودهشة الطبيب الذي يقول له ذات لحظة، وقد بدا له أن حالة المعلم ليست نفسية وحسب، بل عقلية أيضًا
أنت تبدو طبيعيا تمامًا
ثم يضيف لاحقا: عليك أن تحمد الله لأنك لا ترى في منامك ما يُزعج. فكثير من الناس يشكون الهلوسة، والكوابيس، التي تعتادهم في نومهم، وتسبب لهم أعراضًا نفسية وجسمية صعبة، وثمة أناس يحلمون بصوت مسموع، ويثيرون فزع من يشاركونهم غُرفَ النوم، وبعضهم يسيرون وهم نيام، فيرتطمون بالأثاث، وبالأجسام الصلبة، وكمْ من حالم من هؤلاء فقد حياته، فاحمد الله على نعمائه.
لكن وفيقا – وهذا هو اسمه – يثور على الطبيب قائلا ليتني منهم. ومع أنَّ الطبيب النفسي يحاول إقناع المريض بأن حالته هذه لا تستدعي القلق، إلا أن المعلم يشعر بخلاف ذلك «جئت لعيادتك كي تنظر في حالتي، لا لتستهين بي». بعد هذه العبارات تتحول القصة لاتجاه آخر فيصبح المريض طبيبا نفسيا يشرح للدكتور ضرورة الأحلام للكائن الحي، فحتى الحيوانات يا دكتور تحلم، والأجنة في أرحام الأمهات يحلمون. قرأت عن أن الإنسان متوسط ما يراه في منامه من عمره نحو 6 سنوات، وهذه السنوات فقدتها من عمري. وعلى الرغم من ذكاء الطبيب النفسي إلا أنه لم يفلح في إقناع المريض بأن وضعه طبيعي، لكنه استطاع أن ينتزع منه اعترافا مهما وهو، أنه في يقظته يرى أشياء كتلك التي يراها الناس في نومهم، فهو بهذا يقر بأنه يحلم أحلام يقظة، بَيْدَ أنَّ مدرس الرياضيات لا يعترف بتلك الأحلام، فهي في رأيه ذكرياتٌ، وتهيؤات. وقول الطبيب متشدقا ها أنت تعترف.. بأنك تشاهد أحلاما.
قول لا يتعدى التعزية، فأحلام اليقظة شيء والأحلام في المنامات شيء آخر. والمفارقة الساخرة في هذه القصة أنها بعد كل هذا تصل بنا لشيء آخر مختلف، وهو أن الطبيب نفسه لم يشاهد أحلاما منذ أسبوعين أو ثلاثة. ومع هذا يمني نفسه برؤية أحلام جديدة في مقبل الأيام. هكذا تتصف القصة بخفة الروح، والدعابة، والسخرية، أسلوبًا وموضوعًا وشخصيات. فالطبيب الذي وصف على أنه نطاسي بارع هو الآخر يعاني من المشكلة التي يعاني منها المريض، وهي: خلو المنام من الأحلام. ولهذا غادر العيادة، وهو يساوره الندم على تلك الزيارة.
وللطفولة نصيب من هذه القصص، فالطفل يتذكر في «دُوار القدس» زيارته الأولى لها برفقة الجدة، وتتناسل الذكريات واحدة من أخرى إلى أن تصبح القدس محتلة، يحظر على أبناء البلاد زيارة كنيسة القيامة فيها نظرا لاحتلال الغرباء. وفي «شائعة صحيحة» يتندَّر الراوي من الإشاعة التي راجت عن وفاة المطربة الراحلة صباح مرارًا، وهي على قيد الحياة. وقيل إن المطربة التي تجاوزت التسعين كتبت بتأثير من تلك الإشاعات نعيا لنفسها ختمته بعبارة الله يرحمني، ثم دفعت به لممرضة وطلبت منها تزويد الصحف به. جرى ذلك في 25 من نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وتشاء الصدف أن تتوفى المطربة بعد ذلك بيومين. وهذه السخرية تتجدد في قصة «سُنّة الحياة» التي تسخر من سيدة تمتلك الكثير، ولكنها تتهم المستأجرين الذين يقيمون في بيوتها المفروشة، ويغادرون، بسرقة الملاعق والشوك والسكاكين. وعن الاستيطان، وصعوبات التنقل في المحتل من فلسطين، تدور قصة ساخرة أخرى بعنوان «المبيت في حيفا» فميسون التي قدمت من عمان إلى رام الله ترافق الصديق راسم إلى حيفا، وعلى الرغم من أن الاحتلال يشترط على زوار المدينة من القادمين عدم المبيت، إلا أنها حققت ما كانت تحلم به، وتتوق له، فقد شاءت الظروف أن تبيت في المدينة، ولكن في المستشفى لا في فندق، ولا في منزل صديق، «كنت راسمة في دماغي أن أبيت في حيفا، وأن أكسر تعليماتهم، وكما ترى تسهَّلت الشَغْلة.. تسهيلا ربانيا».
ولا تقلُّ السخرية في قصة « دالي في قصر غالا» عن هذه القصة، فالكاتب يحيي باستخدامه هذا اللون العجائبي كلا من سلفادور دالي- الفنان الإسباني- وزوجته التي تجاوزت الثمانين، ومع ذلك تجنح أكثر فأكثر للصخب والانكباب على الموسيقى والشراب.
والمواقف الساخرة في هذه القصة تشبه تلك التي نسج منها الكاتب حكايته عن إبراهيم طوقان ـ الشاعر الفلسطيني المعروف- في قصته «الليلة قبل الأخيرة».
وخلاصة القول إن هذه القصص مع أنها تمثل تراكما جديدا لعطاء الكاتب تضفي في الوقت نفسه لونا آخر على هذا العطاء مزيته السخرية، وخفة الــــروح، والدعابة، مع المزج بين الواقع المتخيل، وتجاوز هذه الواقع إلى الغريب، والعجيب، مما يسبغ على السرد مُتْعة القصّ.
٭ ناقد وأكاديمي من الأردن