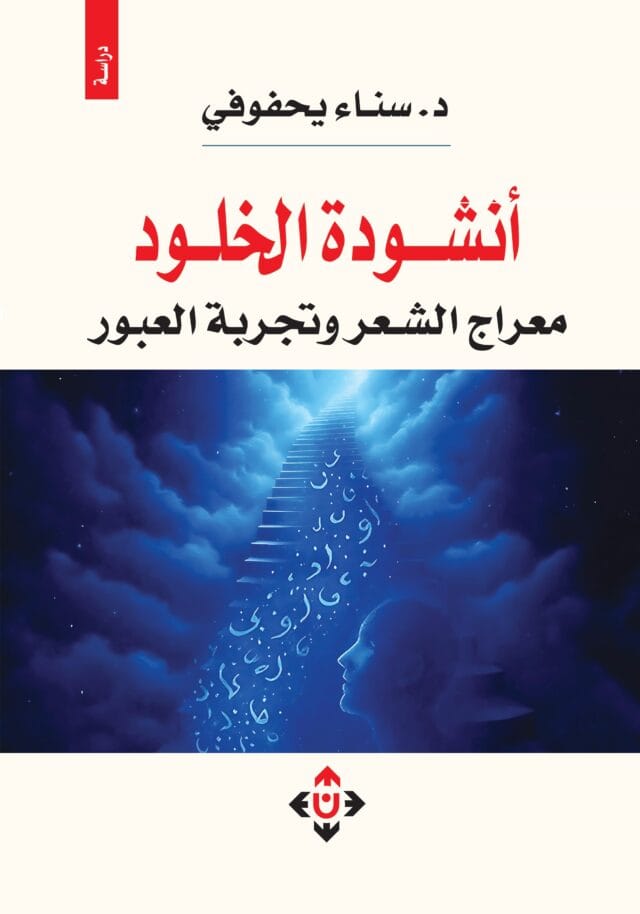class="inline-block portfolio-desc">portfolio
text
الدكتور سلطان المعاني
يستهلّ الكتابُ مشروعَه من عنوانٍ يشي بوجهته: «أنشودة الخلود: معراج الشعر وتجربة العبور». يُعَرِّف نفسه – نصًّا واشتغالاً – كقراءةٍ نقدية في «معلّقات» ديزيره سقّال، ويثبّت بطاقة هويته في الصفحات الأولى: الطبعة الأولى (2026)، عمّان: «الآن ناشرون وموزّعون»، 190 صفحة، ورقم إيداع بدائرة المكتبة الوطنية الأردنية، ليضع القارئ في سياقٍ نشرِيّ واضح ويُعلن انحيازه لفضاء القصيدة العربية قراءةً وتأويلاً لا أرشفةً جافةً للبيانات.
يُقيمُ الكتابُ معمارَه على ثلاث «عتبات» متصاعدة تُحاكي حركة العبور ذاتها: عتبةٌ أولى تمهّد للدخول إلى عوالم الشاعر وسيرورة صوته وتشكُّل مشروع «القصيدة الخالدة»، وعتبةٌ ثانية تُصعِّد الصراع مع الفناء بوصفه «صراع الظلّين»، وعتبةٌ ثالثة تُعلن «نداء البقاء وزمن الحياة». تُقدِّم «فهرس المحتويات» خارطةً دقيقةً لهذا البناء: من «معراج اللغة» و«نحو بلورة مفهوم المعراج الشعري» و«الخلود في وعي الإنسان» و«مرآة الفناء» في مطالع الكتاب، إلى وحدات الألم والتمرّد وتحدّي الموت وإبراز قوّة الشاعر في العتبة الثانية، ثم موضوعات «الحبّ ومرآة الخلود» و«المثال – المرأة الحبيبة» و«تراتيل الفناء» و«عرفانيات ووجد» في العتبة الثالثة، مع محطاتٍ تفكّرية مكرورة بعنوان «بقايا القول» تعمل كوقفات تنفُّس تأويلية بين مقاطع السرد النقدي.
يختارُ الكتابُ ميزانًا نقديًّا يُحاكم به النصوص: ميزان «المعراج الشعري». لا يكتفي بتوظيفه استعارةً حيث يقدِّمه «مفتاحًا تأويليًّا» يعيد تعريف وظيفة اللغة حين تتحوّل من وسيلة بيان إلى سلّمٍ يعبر بالوعي من اليوميّ إلى المطلق، ومن المحسوس إلى الكشف، ومن البلاغة إلى الأثر. تصوغ المؤلِّفة هذا التصوّر بوضوح وهي تعرِّف المعراج بوصفه «اتجاهًا رؤيويًا في قراءة الشعر» يُمَكِّن من استثمار التجربة في أفقٍ تأويليّ–وجوديّ جديد، حيث تغدو «كلّ قصيدة درجةً» في سلّم العبور، ويغدو «كلّ بيت صدى لنداءٍ أعلى» ينقل الشاعر شيئًا من الأبد إلى الزمان.
تؤسِّس القراءةُ، وفق هذا الميزان، علاقةً مختلفة مع «المعلّقة» ذاتها. لا تتعامل مع تسمية «المعلّقات» بوصفها عنوانًا أثريًا مُعلَّقًا على جدار الماضي، فهي تُعيد بناء معناها في المخيال: تُصبح «المعلّقة» فعلَ تعليقٍ بين الأرض والسماء، وطقسًا للعبور نحو أثرٍ خالد، ووسيلةَ رفعٍ للقصيدة إلى مقامها الرؤيوي الذي تتعالق فيه البلاغة بالتجربة. تُسجّل المؤلِّفة هذه النقلة وهي تستعرض جدل الرواية التراثية حول تعليق القصائد على أستار الكعبة، قبل أن تحسم غايتها المنهجية: نقل «المعلّقة» من «الاسم» إلى «الفعل»، ومن الذكرى إلى الإنجاز، ومن السياق المادي إلى التأويل القيمي للخلود.
يُمسكُ الكتاب بخيطٍ ناظم: تحويل الثنائية الفلسفية «الفناء/البقاء» من أطروحةٍ نظرية إلى بوصلة قراءة، ثم تحويل هذه البوصلة إلى تجربة جمالية تُعاش عبر اللغة. يعرضُ القسم الأوّل من العتبة الثانية مسارًا منهجيًّا شفيفًا: «عبور منهجي»، «غنائية الألم»، «ماهية الألم»، «بواعث الألم في معلّقات ديزيره سقّال»، قبل أن ينتقل إلى «رقصة التمرّد» و«تحدّي الموت»؛ أي إن القراءة تلاحق الألم وهو يتحوّل إلى فعلٍ يتحدّى العدم ويستولد الطاقة الشعرية من رحم الوجع.
ينفتحُ الكتاب من بداياته على إشارةٍ جمالية ومعرفيةٍ معًا إلى أنّ النقد هنا لا يُريد أن يشرح «نصًّا» بقدر ما يُريد أن يسافر معه. يكتب مقدِّم «مرآة المسافة» أنّ الدراسة «محاولة جريئة لإعادة الشعر إلى مقامه الكوني، ومعراجٍ وجوديّ يضاهي التجربة الصافية»، وأنها تتجاوز حدود «الفنّ الجمالي» بمعناه التقليدي، وتُغامر لتجعل من القراءة فعلَ عبورٍ إلى الخلود، متجاوزةً حدود البلاغة المدرسية. إنّ هذا التصوّر للمهمّة النقدية يحدد سقف التوقّعات: نقدٌ يصغي لما تفعله القصيدة في الوعي، لا لما تقوله اللغة في ظاهرها.
يتقدّم المنهج إذن بوصفه تزاوجًا بين تأويلٍ نصّي محكم وإطارٍ فلسفيّ يرفد التحليل بمفاهيم الحضور والغياب والزمن والتجلّي. تكشف «فهرسة المصادر» عن شبكة مرجعية واسعة تتجاور فيها نصوص القرآن والكتاب المقدس مع باشلار، هايدغر، لافيل، شيلر، وإلياده، ما يشي بنيّة إدماج التجربة الشعرية في تخاطُبٍ مع أنساقٍ فلسفية وروحانية متعدِّدة تُعين على استجلاء «كيمياء العبور» بين الألم والخلود.
يُعيد الكتابُ تشكيل سيرة الشاعر ومشروعه بوصفهما تمهيدًا معرفيًا للقراءة، لا مجرّد ملحقٍ تعريفي: «النَّبْت الأوّل وجذور التكوين الشعري»، «حياة الشاعر في أفق رمزي»، «الشاعر لغة تتنفّس»، «جذور الضوء»، «تشكّل الصوت»، «من المعلّقة إلى المُعلّى»، «المعلّقات السبع: مشروع زُبدة الحياة»، ثم «رمزية الرقم سبعة» و«المعلّقة السابعة: ذروة العبور وبصمة الخلود»، وهي وحداتٌ تتآزر لتبيّن أن «المعراج» ليس إجراءً قارئًا من خارج النص، فهو منبت من داخل سيرة الصوت وهو يصعد من المحاكاة إلى الإبداع.
يعتمدُ الكتابُ كثيرًا على بناء طبقاتٍ متراكبة من المعنى. يحدّد «الخلود في وعي الإنسان»، و«الخلود في حضرة الامتداد الصامت»، ثم «مرآة الفناء»، و«أصداء الخلود في ذاكرة الزمن»، و«حكمة الفناء ووعد الخلود» بوصفها مفاصل تنظيرية تؤسس لحركة القراءة لاحقًا، حيث يُصبح الألمُ بنيةً مُنتجة للمعنى لا أثرًا عارضًا في النص. يذكِّرنا هذا التسلسل بأن نقد الشعر – حين يجاور الفلسفة – فهو يُسمّي الألم ليستخلص منه «نظام إشارات» يترجم القلق الوجودي إلى طاقة إبداع.
يُحوِّل الكتابُ مفهوم «الألم» من مفردةٍ سيكولوجية إلى مفهومٍ جماليّ؛ يقتبس – أو يلمّح – إلى أطروحةٍ عن كون كبار الفنون تنبثق من «أحسن آثار الألم»، ثم يَسِمُ «التمرّد» بوصفه لحظةَ انكسارٍ تُعيد ترتيب العلاقة بين الجسد واللغة، وتبدِّل وظيفة الإيقاع من زخرفةٍ صوتية إلى إيقاعِ مقاومة. لا يُفاجئنا، والحال هذه، أن تمضي الفصول إلى «تحدّي الموت» و«إبراز قوّة الشاعر»، في تحوّلٍ تدريجي من «وصف المعاناة» إلى «ابتكار استراتيجيةٍ للخلود».
يستثمر الكتابُ في العتبة الثالثة منجز العبور ليبلغ منطقة الحبّ، بوصفه «مرآة الخلود» التي يغتسل فيها الوعي من حدوده الفردية نحو «نحنُ» كونيةٍ تُشبِه طقسًا يُصَيِّر الحبيبة «مثالاً» يعقد المصالحة بين الجمال والمعنى. تُعلّق المؤلِّفة على قصيدةٍ تتشكّل خاتمةً ميتافيزيقية لمسار الحبّ: فلا تُعيد إنتاج ثنائية العاشق والمعشوق في سردٍ غنائيّ، فهي تجعل «المعراج» ذاته هو حركة الحبّ، حيث تصير الحبيبة مرآةً للاكتمال وليست موضوعَ امتلاك. هكذا يتجاوز الحبّ «النرجسية» إلى توحيدٍ كونيٍّ تنهض به القصيدة لتبذل «أثر الخلود» في قارئها.
يُزاوج الأسلوبُ بين صرامة التحليل وحِسٍّ تعبيريٍّ شاعري. تُضاء مفردات المعراج والنور والنداء؛ تتتابع ثنائيات العبور/المكوث، الفناء/البقاء، الخفوت/السطوع؛ يتوالى التصعيد عبر عناوين قصيرة مُوحية: «مرآة الفناء»، «بقايا القول»، «التماعة أخيرة»، «وميض الختام وساعة العبور». تُستَخدم هذه العناوين لتقسيم التجربة إلى طبقاتٍ قابلةٍ للتسرية داخل الوعي، فيغدو الكتاب نفسه «سُلَّم قراءة» تتدرّج درجاته بموسيقى المعنى.
وتُرى الصياغة – في مواضع الافتتاح – تُصرِّح بمزاجها الشعري: تُلوّن الواقع بالحلم، وتسمع للغة همسًا يتماهى مع «موسيقى الكون»، وتستعير صور «المجرة» و«اللحن الأخير» لتعلن منذ الفقرة الأولى أن النقد هنا سيتنفّس ببلاغة النص الذي يقرأه. لا يُفهم هذا التلوين بوصفه تخلّيًا عن التحليل؛ إنما هو رهانٌ مُسبق على أن الطريق إلى المعنى يمرّ من «درجة الإشراق» التي تُنير المفاهيمَ قبل أن تُقننها.
على صعيد الأدوات، يُكثر الكتاب من «الفواصل التأملية» الموسومة بعنوان «بقايا القول». تؤدّي هذه المقاطع وظيفة «الاستراحة التأويلية» التي تُعيد ترتيب الخلاصات قبل الانتقال إلى عتبةٍ أعلى، فتمنح القراءة إيقاعًا تنفُّسيًا يمنعها من السقوط في رتابة البرهنة، ويُذكِّر بأن العبور يتناغم مع «التماعة أخيرة» في خواتيم الأقسام، حيث يُختزل المسار في ومضةٍ تلمع ثم تُسلم القارئ إلى درجةٍ تالية.
ويحسن الكتاب – وهو يُشَيِّدُ جسوره الفلسفية – أن يربط التجربة بمواردها الدينية: تُستحضر آيات التجلّي و«ميقات الرؤية» في خطابٍ يؤكّد أنّ المعراج الشعري حركةُ وعيٍ تُشبه «الهبوط من مقام النور» إلى اللغة، حيث يُغتسل الشاعر في أنوار الحقيقة ثم يعود ليصوغ أثرها في بيتٍ وصورةٍ ومجاز. يوظّف هذا الالتحام النصي لإسناد أطروحته: المعراج كشفٌ يُصاغُ شعراً لا مفهوماً مجرّداً.
وتُحسن المؤلِّفة كذلك ضبط مسافةٍ نقدية مع موضوعها؛ تُبرزُ قوّة الشاعر حين يتحدّى الموت ويُؤسّس لغته على إصرارٍ وجوديّ، لكنها في الوقت نفسه تُخضع هذه القوة لمعيارها الأعلى: مقدار ما تُحدثه من عبورٍ في الوعي. هنا يُصبح سؤال القيمة مرتبطًا بقدرة النص على اختراق «زمن الاستعجال» وسوق الاستهلاك وإعادة الشعر إلى «مقامه الكوني». يعودُ الرهان على الزخرف والدُّربة الأسلوبية وعلى تكوين «أثرٍ» يبقى بعد انطفاء اللفظ؛ أثرٍ يجعل القصيدة «حياةً لا تموت»، كما يلمّح الكتاب في مواضع متفرّقة.
وتتجلّى إحدى نقاط القوة في أنّ الكتاب لا يفصل «الوعي الجمالي» عن «المعرفة بالتراث». حين يعيد تنضيد معنى «المعلّقة»، يُحافظ على حرارة الذاكرة العربية ويزجّ بها في مختبر قراءةٍ معاصرة، فيتحرّك بين النصّ القديم والكتابة الحديثة بسلاسةٍ تمكِّن القارئ من الشعور بأن «الخلود» ممارسةٌ لغوية وروحية تتكرّر في أزمنتنا الجديدة بوسائطَ وأطرٍ مختلفة. تُترجم هذه السلاسة في مفاصل مثل «من المعلّقة إلى المُعلّى» و«رمزية الرقم سبعة»، حيث يتقاطع السيميائي بالأنثروبولوجي، وتستعيد القراءة مقاديرها من رموز المقدّس، وبلاغة الأعداد، وإيقاع الطقس.
وإذا كان لا بدّ من التنبيه إلى مواطن يمكن أن تُثري الكتاب أكثر، فيمكن القول إنّ حرارة اللغة – وهي فضيلةٌ أصيلة هنا – قد تُغري أحيانًا ببسط المجاز على حساب مزيدٍ من الانضغاط البنيوي؛ فالقارئ الخبير قد يطلب، في مواضع محدّدة من العتبة الثانية، تمتينًا إضافيًّا لشبكة الإحالات النصيّة داخل الديوان نفسه (التقاط التيمات العائدة وتفكيك تكرارها الإيقاعي بمقاييس كمية، مثلاً)، لاسيّما وأنّ «بواعث الألم» و«غنائية الألم» و«ماهية الألم» موضوعاتٌ تصلح لاقتراح مصفوفات مقارنة (مفردات، صور، أوزان) تعزّز دعوى التحوّل من الألم إلى الخلود. ومع ذلك لا يَحُولُ هذا الاقتراح دون الاعتراف بأن البناء الحالي – بوقوفاته «بقايا القول» – يلبّي، في مستوىً معتبر، الحاجة إلى الاستدراك والتلخيص داخل حركة العبور.
وتُحسن المؤلِّفةُ اختيار ذُرى سردية داخل العمل، فتجعل من «المعلّقة السابعة» ذروة عبورٍ وبصمة خلودٍ، وتراهن أن يكون «الترتيب» – لا «العشوائية» – جزءًا من دلالات المشروع؛ إذ يُغلق القوس بما يليق بالمعراج: «وميض الختام وساعة العبور» التي تُعيد تركيب التجربة في لحظة تكثيف. يبدو هذا التتويج عودةً إلى السؤال الأول: هل نجحت القصيدة في نقل ما يشبه «جزءًا من الأبد» إلى الزمان البشري؟ يُجيب الكتابُ بنعم، عبر مزيجٍ من البرهنة و«الإنشاد» النقدي.
ويقدِّم النصّ، في مشاهد الحبّ، برهانًا عمليًّا على أطروحته: تُبرِز القراءة كيف يغدو العشق معراجًا، وكيف تتحوّل الحبيبة إلى «مثال» تُصالح من خلاله الذات بين ذروة الجمالي وسمتِ المعنى. لا يُعاد تدوير قوالب الغزل، حيث يُعاد ترتيب علاقة الذات بذاتها وبالآخر، لتولد «نحنُ» تُحاكي اتساعَ الكون. تنضبط اللغة هنا بمزاجٍ عرفانيٍّ يلوّح ولا يُصرِّح، ويُحافظ على خيطٍ نقديّ يمنعها من الغرق في الغنائية.
وتنجز القراءة – في مستويات متفرّقة – وصلًا بين الاستعارة الكبرى (المعراج) وأنساقٍ صغرى تشغِّلها: «مرآة»، «نداء»، «تماعة»، «بقايا قول». يُحسن هذا التشبيكُ تخليقَ معجمٍ داخليٍّ للكتاب، بحيث يشعر القارئ أنه أمام «مقامات» متوالية يتبدّل فيها المقام ويثبتُ اللحن. تتجلّى براعة الصياغة في جعل المصطلح النقدي نفسه جزءًا من موسيقى القراءة، فتستوي «مرآة الفناء» عنوانًا ومنهجًا، و«نداء البقاء» عنوانًا وغايةً معًا.
ويختم الكتابُ مساره بتجربة «وميض» قصيرة باللغة الإنجليزية، كأنّها نافذةٌ جانبية تعكس سرَّ البقاء وحلم الخلود في جملةٍ مقتضبة؛ بوصفها تذكير بأن المعراج يتحدّث بلغاتٍ عدّة ما دام أثره واحدًا. تُضيف هذه اللمسة المتقشِّفة طبقةً دلاليةً تُحدِّث القارئ غير العربي، وتؤكِّد نزعة الانفتاح التي طبعَت القراءة ككل.
تخلُص هذه القراءة التعريفية–التحليلية إلى أنّ «أنشودة الخلود» لا يعرض «نظريةً في الشعر» بقدر ما يُمارس الشعر نقدًا. يَصِف المعراج لكي «يصعد به» في بنية الكتاب وأفعاله وعناوينه وإيقاع وقوفاته. يُعيد تسييل مفاهيم الألم والزمن والوجود في جسد القصيدة، ويُعيد تربية الذائقة على الإصغاء للقصيدة «كأثرٍ يعيش»، لا كحيلة بلاغيةٍ تحسن الإيهام. ينجحُ الكتابُ – في أغلب فصوله – في جعل القارئ يُحِسّ أنّه يصعد في المعراج؛ لا يسمع «حديثًا عن الخلود»، وإنما يختبرُ «وعد البقاء» وهو يتكثّف في اللغة. يُكسب هذا الرهانُ العملَ فرادته داخل مشهد النقد العربي المعاصر: يجرؤ أن يُوقِّع اسمه قرب القصيدة، لا خلفها؛ أن يكتب نقدًا بصوتٍ حارٍّ لا يذوب في الغنائية، وأن يزن القيمة بميزان الأثر التحويلي لا بسطح الحيلة البيانية. من هنا يبدو «المعراج الشعري» في الكتاب أقلّ من أن يكون استعارة، وأكثر من أن يكون منهجًا: يبدو «طريقةَ سلوك» في القراءة، تُعيد للنقد سؤاله الأول: ماذا تصنع القصيدة بنا؟ والجواب – كما يقترحه الكتاب – يصعد سلّمًا سلّمًا، حتى يلمع «وميض الختام» ساعة العبور.
(صحيفة الدستور، 17/10/2025)