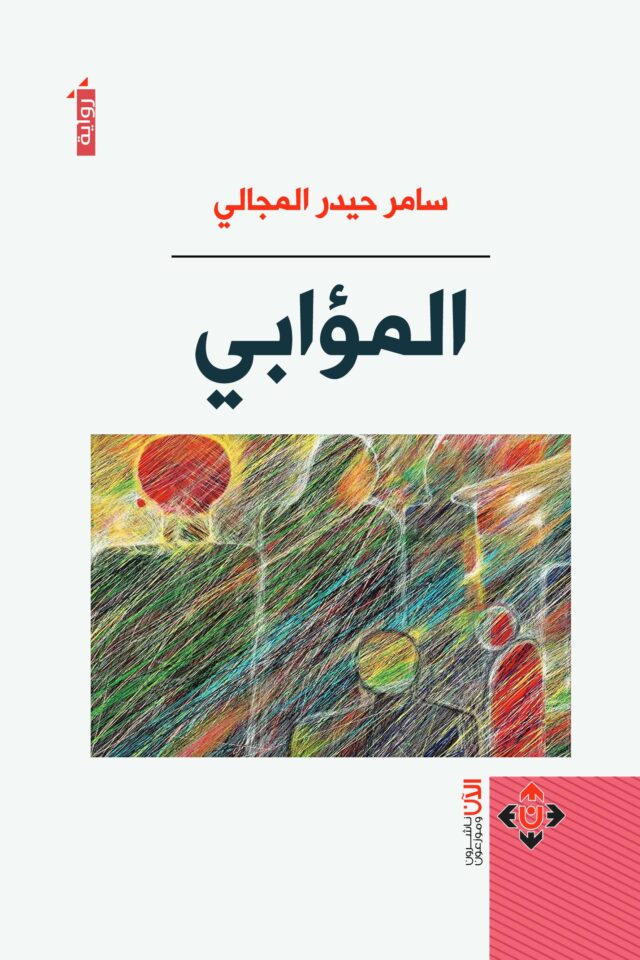class="inline-block portfolio-desc">portfolio
text
نايف النوايسة
من المؤكد أن الرواية كجنس أدبي أيّا كان نوعها هي خطاب إبداعي يتوجه به كاتبه إلى المتلقي المثقف كاشفاً عن رؤيته الفكرية في الحياة ومسارتها المتشعبة.
تستوقفني الرواية التاريخية أو التي تقع ضمن المتخيل التاريخ كما يذهب البعض في تسميتها، لأني أفترض في هذه الرواية لحظة تنوير لفكرة أدرك الروائي أهميتها وقداسة مضمونها، بحيث يراها عظيمة وجديرة بالاهتمام، بخاصة إذا وُظفت أحداثُها التاريخية توظيفاً يخدمها وكُتبت بأسلوب فني عالي المستوى، ولم يتورط بالضياع في السرد ما بين (التاريخي الحرفي والفني).
ولا أجد غضاضة في الرواية التي تُجسّد حالة تاريخية ما يُشهد لها بالاحترام على أن يقوم الروائي في مختبره الإبداعي بتفكيكها وإعادة انتاجها من جديد لينقل التاريخي إلى الفني ليس سارداً حسب،وإنما معظِّمٌ لفكرة جليلة ولمعانٍ سامية عمّت إيجابياتها بين الناس وصارت جزءاً مما توافقوا عليه، وقد تكون هذه الحالة متعينة بشخص أو جماعة أو بكليهما.
إن ما قاله الدكتور سعيد يقطين في مقالاته حول هذا الموضوع لجدير بالاهتمام: (العلاقة بين الرواية والتاريخ لا ينبغي أن تُردم) وقال: (.. ولكن علينا أن نعمل على استكشافها لمعاينة كيف يبني الروائي علاقته بالتاريخ؟ وبأي طريقة؟ ولأي مقاصد؟)، وهو أمر مهم ذهب إليه الدكتور يقطين واستيقنته بوضوح وأنا أقلّب صفحات هذه رواية( المؤابي) للأديب سامر المجالي.
من الصفحة الأولى للرواية ومفهوم السيادة والزعامة يلح عليّ ويطفو على سطح ما استوعيت منها، واستهدفت في رحلتي البحث عن نقطة الارتكاز التي التفّتْ من حولها الرواية في أحداثها وشخوصها وأماكن الفعل الإنساني فيها، فوجدت أن العبور إلى فضاءاتها يتم من ولوج بوابة التاريخ لتأكيد مفهوم(السيادة)، والكيفية التي يتحقق بها هذا المفهوم، وفي ذهني في الوقت ذاته ما صنعه ابن خلدون في مقدمته وهو يبحث في علم العمران أو الاجتماع، ولعل الروائي المجالي ذهب إلى ما ذهب إليه ابن خلدون لطرْق أبواب علم جديد هو(علم السيادة)، كل ذلك تم بلغة قوية محكمة حِيكت فيها حبكة الرواية، ومعالجات منطقية لا خلل في وجودها بالجسم الفني للرواية.
أقول بدءاً: لا مثلبة في الكتابة عن جماعة ما وتتبعِ تاريخها إن كانت هذه الجماعة ذات تاريخ مُشرّف وحضور ايجابي فاعل في بناء حياة الإنسان والمجتمعات، فكيف إذا قام المبدع بتحليل هذا التاريخ أو بعضه ويعيد إنتاجه عملاً إبداعياً عالي المستوى كهذه الرواية وقد التزم فيها مساراً سردياً واحداً لا مساران، هو المسار الفني، فلم يضطرب قلمه ما بين التاريخي والفني.
وفي يقيني أن الأديب المجالي رجع إلى مصادر تاريخية كثيرة ليقف من خلالها على تاريخ العشيرة المستهدفة فضلاً عمّا يعرفه عنها واستقر في ذاكرته، ليلتمس له في ما بعد طريقاً آمناً في صنع روايته، فانتقى من طيّب ما تحصّل له أطيبه، وراح يعالج فنياً نسيج روايته، كأسماء الأشخاص والأماكن، ما عدا بعض الشخصيات التي ظنها لا تكشف أقنعته مثل الشخصيات التركية والعربية، أما الشخصيات الكركية فأتقن اخفاءها، ووجد في شخصية عدنان البطل الأنمودج والحامل القادر لأعباء الخيوط المتشابكة لهذا العمل؛ واستمد دلالة الاسم من عمق تاريخي معلوم هو (عدنان جد العرب)، وربطه بمؤاب التي لها دلالات شاهدة على السيادة وبناء الدولة ومقاومة الظلم في الكرك وما جاورها من حواضر.
وفي الرواية: ظهرت على عدنان مخايل الخير وتباشير الزعامة منذ صباه وتشرّب ذلك من كبار عشيرته وما يسمعه من مآثر، كل ذلك طبعه بميسم الزعامة، فسار في عدة خطوط مكنته من سنام السيادة كما خطط الروائي؛ الخط الأول هو مراتع الصبا التي أفضت في ما بعد إلى مواجهة (البرغوث) الذي تمرد على ثوابت الشيخة والسيادة وتزعم انتفاضة ضد زعماء العشيرة كالذي فعله الصعاليك قديماً في حركتهم الاجتماعية المعروفة، وتمكن عدنان ومن معه من مناصرين وعلى رأسهم أولاد أخيه من القضاء على البرغوث واجتثاث حركته، فعظُم عدنان في عيون جماعته وأصبح زعيمهم دون منازع.
لم تكن عين السلطة العثمانية غافلة عمّا يدور في ولايات الدولة ومنها الكرك، ولاحظت قوة التمكين والزعامة التي تحصّلت لعدنان بين جماعته وفي محيط المنطقة، ومدّ عينه إلى البعيد، وهل هناك غير رأس السلطة في اسطنبول من مرام؟! وتشابكت الخيوط بين السلطان عبدالحميد وزعماء القبائل في الوطن العربي ومنهم عدنان الذي تسلّم خطاباً من السلطنة معنوناً بـ(عدنان بن كريم المؤابي) وتضمّن دعوته لمقابلة السلطان عبدالحميد، والذي نلحظه هنا أن صفة(المؤابي) خُصّ بها عدنان ولم تلحق بغالب بن عويد، وسأوضح الأمر لاحقاً.
وكيف تكون السيادة؟ وهو الهاجس الذي لا يفارق عدنان منذ فتح عينيه على الحياة، والحلم الذي يسكنه ويسعى إليه في الليل والنهار، من هنا أمسك الروائي بخيوط روايته وجعل وجهة السرد وحركة الشخصيات وجوهر الأحداث باتجاه نهج عدنان الذي أوحى بأنه شخصية قوية استثنائية من خلال المواجهة مع البرغوث ودحره، فبزغت منابت زعامته، ثم ذهب الروائي إلى بوابة ثانية هي (سلامة بن زعل) التي حملته إلى مُبوّأ الزعامة، فسلامة فتى موهوب وذكي وطموح اختاره عدنان من بين صبيان العشيرة ليدرس الإدارة والسياسة والعلوم العسكرية في مدرسة أبناء العشائر التي أنشأها السلطان عبدالحميد في اسطنبول في أواخر حكمه، وفي الوقت ذاته أرسل عدنان ابنه فارس الى مكتب دمشق لينال حظاً من العلم كأبناء الذوات ليقينه أن الاستثمار في العلم هو أفضل استثمار لتحصيل السيادة.