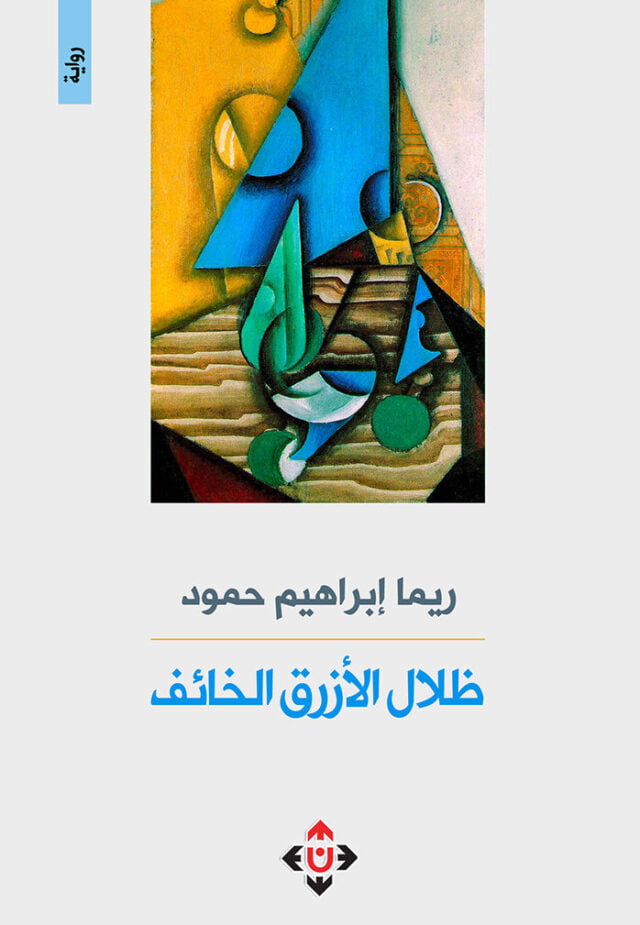class="inline-block portfolio-desc">portfolio
text
موسى أبو رياش
«ظلال الأزرق الخائف» للروائية الأردنية ريما إبراهيم حمود، رواية تصور تأثيرات حرب أهلية على مجموعة من الجيران، كمقطع معبر ودال على الحرب ومآسيها بشكل عام، ولم تحدد الرواية المكان ولا الزمان، وإن كان المكان أقرب لجزء من حي في مدينة سورية، بحكم استخدام البراميل المتفجرة كعلامة فارقة لقصف الأحياء، ولكنها تصلح كنموذج للمعاناة الإنسانية في أي مكان عربي يعاني من احتراب داخلي مسلح بين السلطة الحاكمة ومعارضيها، حيث الإنسان المواطن هو الضحية ووقود الصراع، الذي قد تكون أسبابه في الغالب لا تهدف لتحرير المواطن وكرامته، بقدر ما تسعى لتحقيقه من مصالح ومكاسب وسلطة للأطراف المتصارعة، التي لا تأبه للمواطن إلا بقدر دوره في وصولها إلى أهدافها وإن على جثته.
اعتمدت الرواية تقنية تعدد الأصوات بالتناوب وهي أصوات: نور وعلياء وفاطمة والقبو وحسن، ولكن صوت حسن لم يكن مباشرًا، فقد ناب عنه راوٍ عليم، دلالة عن الغياب والضبابية والغموض في شخصيته، وهذا يتفق مع السياق، فقد كان حسن الشخصية الأبرز في الرواية، والأكثر تأثيرًا وحضورًا على الرغم من جنونه وتصرفاته وغموضه.
لم تنسج الكاتبة روايتها على أصوات القذائف وأزيز الرصاص فحسب، بل أثثتها على قصص وحكايات شخوصها قبل الحرب، فهي تتعامل مع شخوص إنسانية حية عاشت حياتها قبل الحرب، بما فيها من معاناة ومشكلات وآمال وأحلام وآلام وانتكاسات واستغلال وخصومات، فلكل شخصية خلفيتها الإنسانية المحملة بالحياة، وعندما داهمت الحرب منطقتهم، لجأ الجيران إلى قبو عمارة أبي حسن الذي جهزه كملجأ في أثناء الغارات وتساقط البراميل والصواريخ على الحي، وكان القبو خير مستقبل لهؤلاء الجيران، احتضنهم بحب وحنان، ووفر لهم الأمان، ولا غرابة أن ألفهم وألفوه، وأنس بهم وأنسوا به، فصار له لسان وصوت كان بارزًا في الرواية، لا يمكن تجاهله، وهذا يتوافق مع دوره في إيواء الخائفين، الباحثين عن مكان يأمنون به ويوفر لهم الحماية من بطش الحرب وجبروتها وإن إلى حين، وهذا ما أكده القبو في النهاية، أنه لم يعد يحتمل شدة القصف، لكأنه يعاني مثلما الناس ويتألم ويُقتل، وهذا ما كان.
تبدو قصص ومعاناة نور وفاطمة وعلياء ومريم وبقية الشخوص من الناحية الحياتية والاجتماعية عادية ومكررة، وهي من لوازم المجتمعات العربية، مع اختلافات ظرفية هنا وهناك، أما الحرب، فهي عادلة بقسوتها مع الجميع، لا تفرق بين كبير وصغير، وبين ذكر وأنثى. ولكن الشخصية الأبرز كما أشرنا سابقًا، هي شخصية حسن، فهي شخصية مركبة معقدة محيرة غامضة ضبابية متقلبة في الآن نفسه، فحسن العبقري منذ صغره، خريج الدكتوراه من أمريكا، كان يحب ابنة عمه منال منذ صغرهما، ولكن عمه استبق عودته بشهاداته بأسبوع، وزوجها من ثري، وضرب عرض الحائط برجاء أخيه، ومشاعر ابنته، وحب ابن أخيه المعلن، فانتكس حسن، وصار أقرب إلى الجنون، يجري وراءه الأطفال يضربونه بالحصى، وينادونه بحسن المجنون، ولكن للغرابة، كانت نساء الحارة يستعنَّ به لتعليم أولادهن الرياضيات والفيزياء، فلم يتردد بالشرح والتدريس ووصفهم بالحمير.
لم تنسج الكاتبة روايتها على أصوات القذائف وأزيز الرصاص فحسب، بل أثثتها على قصص وحكايات شخوصها قبل الحرب، فهي تتعامل مع شخوص إنسانية حية عاشت حياتها قبل الحرب
كان حسن مجنون منال، ولكنه لما رأى علياء التي تكبره بسنوات مال إليها، وأخذ يراقبها بجرأة، وتوجهت عواطفه نحوها، ولما عصفت الحرب بحارته، اختفى فجأة، ثم ظهر فجأة، وتزوج علياء التي رأت فيه ملاذًا وسط عواصف الوحدة والتجاهل من الجميع، وتنكر الأهل لها، تزوجته واحتمت به لتنسى علاقة عاصفة كانت مع الطبيب باسم في الكويت، الذي استغلها، وطردته من حياتها بعد أن أخبرها أن علاقته معها للتسلية والمتعة، أما الزواج فقيد لا يرضاه. نفوذ حسن كان واضحًا وسط رحى الحرب الدائرة، فهو كان مع شباب المعارضة المدافعين عن الحي، ولكنه كان رتبة محترمة مع الجنود الذين يهاجمونهم، وكان صاحب نفوذ وكلمة مسموعة لدى الطرفين، أي أنه كان يعمل لدى الجهتين، ولكن مع من كان فعلًا، ومن يخون؟ على الأغلب أنه كان مع الجنود، تأكيدًا لما أطلقه عليه رجال الحي من قبل أنه «من المخابرات»، ولكن يبدو أن هذه النقطة بالذات إشكالية وفيها لبس، فحسن كان معروفًا بجنونه، ولم يكن له علاقة بالجيش، فكيف أصبح فجأة ضابطًا في الجيش وله صلاته الحكومية الواسعة، التي مكنته من الحركة والتنقل في غير مكان، واللعب على الحبلين؟
أظهر حسن في عمله أنه قاتل شرس، ينكل بالمواطنين ولا يرحم، خان شباب المقاومة، وعندما اكتشفت زوجته علياء ذلك، تبرأت منه، ورفضت الانصياع لأمره وطلباته، وهاجمته كلبؤة، فانتكس، وعاد سيرته الأولى، وناداها منال، وانتهى أمره حبيس قبو مهدم منزوٍ على نفسه، يحتضن شهاداته وفي عينيه حيرة مجنونة. وكأن مدة علاقته بعلياء كانت فترة صحو من جنونه، فترة معترضة من الجنون، ولكنها كانت جنونًا من نوع مختلف، جنون الحب، وجنون القتل والبطش، وجنون الانتقام من المجتمع، وجنون اللعب على الحبال، وجنون الخيانة. وهو في حقيقته أخطر وأكثر تدميرًا، فجنونه الأول؛ جنون منال، كان أرحم، وأقل ضررًا، بل كان مفيدًا في جوانب كثيرة، لا أقلها تدريسه لأبناء الجيران، ومساعدته في حمل الأغراض لهم.
حسن بجنونه وتناقضاته وتقلباته وغموضه، نموذج حي للحرب الأهلية بلا منطقيتها ومعقوليتها، فالحرب الأهلية حرب مجنونة تأكل الأخضر واليابس، لا حدود فاصلة لها ولا أهداف واضحة، لا تعرف متى تأتيها نوبة الجنون؟ ومتى تصحو إن صحت؟ تبقي ضحاياها على شفير الموت في كل لحظة، يترصدهم الرعب والخوف في كل مكان ومن أي كان، فالكل معهم والكل عليهم في الآن نفسه. شخصية حسن كانت مغامرة روائية للكاتبة، أبدعت في رسم معالمها، والغوص في بعض تفاصيلها، وإدارة تقلباتها وعواصفها، ولكن بقيت بعض الجوانب غامضة في حاجةإلى إضاءات، وكان بالإمكان الغوص أعمق في تعقيداتها، والكشف عن بعض خفاياها وأبعادها. نعم ألمحت الكاتبة إلى بعض أسرارها، لكن الخيوط لم تكن كافية لتلتئم التفاصيل.
نهاية الرواية جاءت مفتوحة على احتمالات شتى تميل إلى السوداوية والضبابية، فلا انفراجه في الأفق، فالنساء اللواتي هاجرن بقارب مطاطي، بقي مصيرهن معلقًا في رحم الغيب، هل يصلن إلى وجهتهن أم لا؟ خاصة وأن قوارب المهربين تحمل أضعاف حمولتها القانونية، ما يجعل الجميع برسم الغرق والموت في أي لحظة؟ وهل هجرة الوطن ابتداءً نهاية سعيدة أم هي هروب وفقدان وخسارة وضياع وتيه في الأرض؟ كما أن الحي تدمر عن بكرة أبيه بما فيه القبو، وتعرضت بيوته من قبل للسطو والسرقة، وعاد حسن سيرته الأولى من الجنون والانكفاء والنكوص إلى حبه الأول؛ حب منال. وكلها نهايات محبطة، ترسم مستقبلًا قاتمًا ولا أمل يبدو في الأفق، وعلى كل حال، فليس مطلوبًا من الرواية أن تدغدغ القارئ بنهاية مثالية بدون أن يكون لها رصيد على أرض الواقع، فلا شيء عربيًا يبشر بالفرح؛ لا في دول الاحتراب الداخلي أو غيرها، فكلها في صراعات داخلية مع الفساد والغلاء والبطالة والفقر وغياب الحريات والظلم والمحسوبيات والطبقيات وغيرها من عوامل هدم المجتمعات وأفول الدول.
وبعد؛ فإن رواية «ظلال الأزرق الخائف، 188 صفحة، الآن ناشرون موزعون ، 2020»، هي الثالثة للكاتبة بعد روايتيها: «أيام جميلة، 2015»، و«الهوية، 2017»، ومجموعتين قصصيتين: «جريمة عطر، 2013»، و«بالونات، 2014». وهي رواية تميزت بسردها السلس، ولغتها الجميلة، وسبكها المحكم، وغوصها في أعماق الشخوص، ونقلت جانبًا من معاناة المواطنين وقود الحروب الداخلية وضحاياها وأكبر الخاسرين فيها، مؤكدة دور الأدب في تلمس معاناة هؤلاء، مشتبكًا ومصورًا وناقلًا لها، ليضع القارئ أمام مسؤولياته تجاه هؤلاء، بالوعي بقضيتهم ومأساتهم، والتفاعل معها، والضغط من أجل إيجاد حلول تحفظ حقوقهم وكرامتهم، وإنسانيتهم قبل كل شيء وبعده.
٭ كاتب أردني