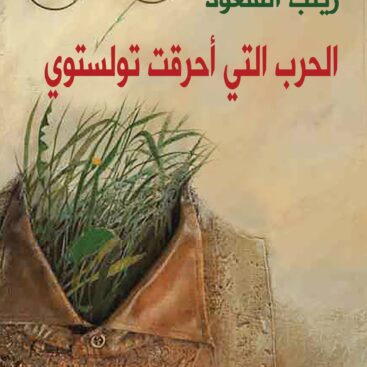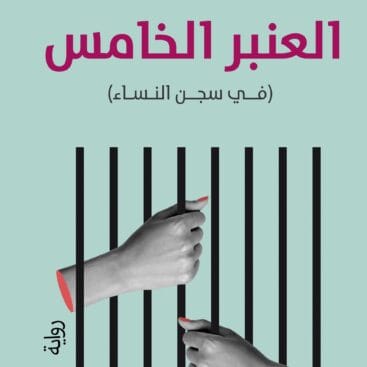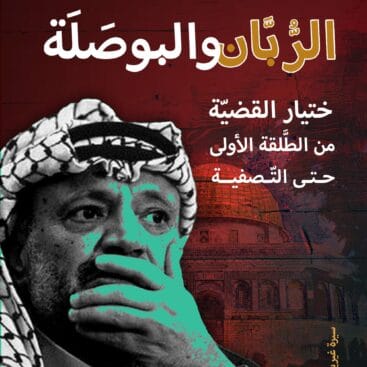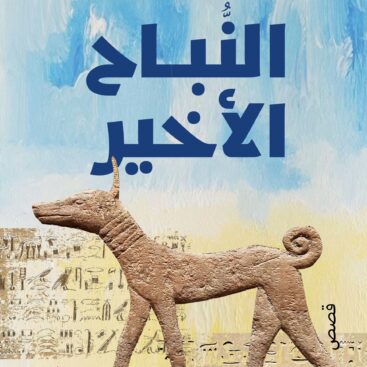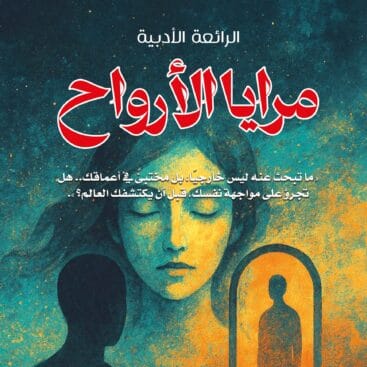قراءة صحفية وأكاديمية في كتاب: ترابط العالم: ما وراء مبادرة الحزام والطريق
"عندما توجَّهتُ شرقًا"من كتاب ترابط العالم: ما وراء مبادرة "الحزام والطَّريق"الصين بعينٍ عربية: ما وراء “الحزام والطريق” كما ترويه لُجين في زمنٍ عربيٍّ تتنازعه الحروب والعقوبات، ويعجز فيه كثيرٌ من الدول عن إعادة البناء، يظهر كتابٌ عربيٌّ يحاول أن ينظر إلى الصين لا بوصفها "لغزًا" ولا "مخلّصًا"، بل تجربةً تاريخيةً قابلة للتأمل. لُجين—كاتبة سورية جاءت إلى الصين من ذاكرة بلدٍ مثقوب—تكتب عن "الحزام والطريق" . لكنها تذهب أبعد من الطرق والجسور: إلى سؤال الإنسان، وفلسفة الحكم، ومعنى التنمية حين تصبح مشروعًا وطنيًا لا شعارًا موسميًا.لماذا نحتاج هذا الكتاب الآن؟ليس جديدًا أن يكتب العرب عن الصين، لكن الجديد هنا هو زاوية النظر. فكثيرٌ من الكتابات العربية تقف عند "لصين الاقتصادية": أرقام النمو، المصانع، صادرات التكنولوجيا، أو صراعها مع واشنطن. وكتابات أخرى تنزلق إلى طرفين متقابلين: الانبهار السهل الذي يحوّل التجربة إلى أسطورة، أو الشكّ المطلق الذي يختزلها في مؤامرة. بين هذين الطرفين يختار كتاب الدكتورة لُجين مسارًا ثالثًا أكثر نضجًا: مسارًا ينطلق من تجربة شخصية ومعرفةٍ دراسية، لكنه يُصرّ على تحويل التجربة إلى أسئلة عامة تخصّ "الجنوب النامي"—ذلك العالم الذي يعرف الفقر والحصار وضعف الدولة، ثم يبحث عن طريق خروج لا يشبه الوعود الخطابية.تكتب الدكتورة لُجين من موقعٍ غير محايد بالمعنى البارد للكلمة؛ فهي ابنة بلدٍ مجروح. غير أن هذا الانحياز...