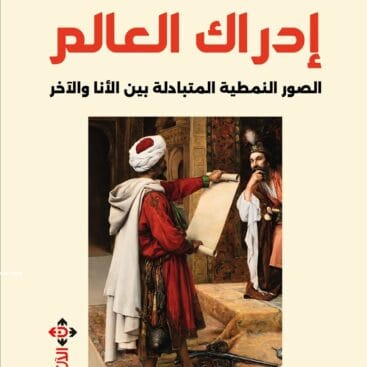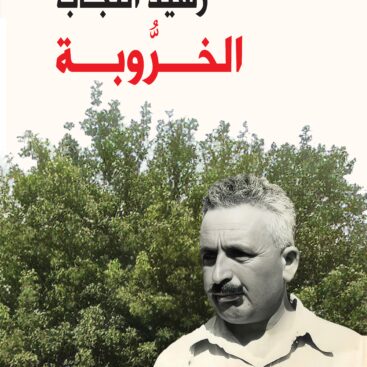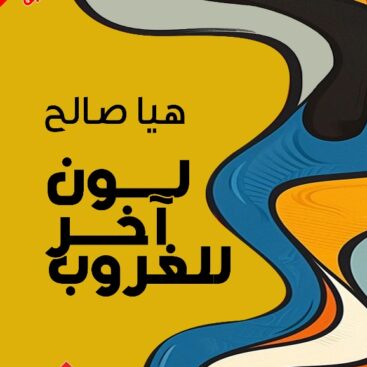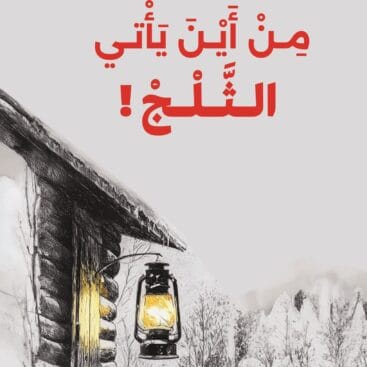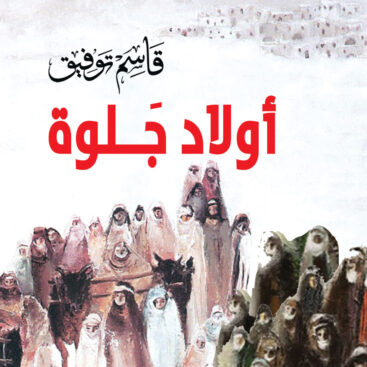الهجرة إلى المجهول: قراءة في رواية “مراكب الكريستال” للأديب الإرتري أبو بكر حامد كهال
دراسة بقلم: د. شعبان عبد الجيِّدحين انتهيت من قراءة رواية “مراكب الكريستال” للأديب الإرتري أبو بكر حامد كهال، تأكد لي ما استقر عند أكثر النقاد المعاصرين، من أن الرواية، من بين الفنون الأدبية كلِّها، تبدو جنسًا أدبيًّا مراوغًا، شكلًا ومضمونًا، فليس لها إطار محدَّد، ولا قواعد ثابتة، ولا يمكن أن نحصر أشكالَها أو نستقصيَ موضوعاتها؛ فكاتبها يسرد الأحداث دون أن يقيده الزمان ولا المكان، ودون أن تحدَّه ضوابطُ الطول أو القِصَر، كما أنه ليس مقيَّد اليدين إزاء الوصف والاستطراد وعدد الشخصيات، وهو ما نجده بتمامه في هذه الرواية. تقع “مراكب الكريستال” في أقل من سبعين صفحةً من القطع المتوسط،، تُقرَأُ كاملةً في جلسةٍ واحدة. وهو ما يجعلها، من حيث الحجم على الأقل، رواية قصيرة Novelette، وهي قصة سردية نثرية، أطول من القصة القصيرة وأقصر من الرواية الطويلة. جاءت وكأنما كُتبت دفعةً واحدة، غير مقسمة على فصول، ولعل هذا ما جعلها تركز على حدثٍ واحد، وفكرة واحدة، وموضوع محدَّد، وتعتمد على عددٍ محدودٍ من الشخصيات الرئيسية، وعددٍ قليلٍ من الشخصيات الثانوية. لكنها تترك انطباعًا قويًّا لدى القارئ، تمامًا مثلما تمثل همًّا مورِّقًا في ضمير الكاتب. • رواياتٌ أخرى للمؤلف: ولا أدري لماذا أحسُّ أن الأستاذ أبو بكر كهال على عجلة من أمره فيما يخرج لنا من قصص وروايات؛ ويبدو كأنما أحدٌ يلاحقه وهو...