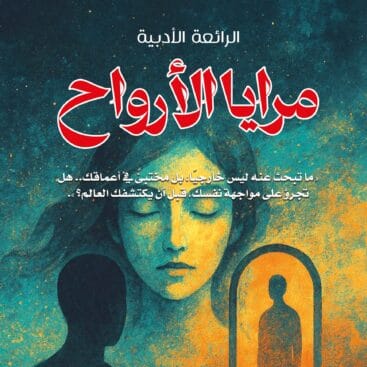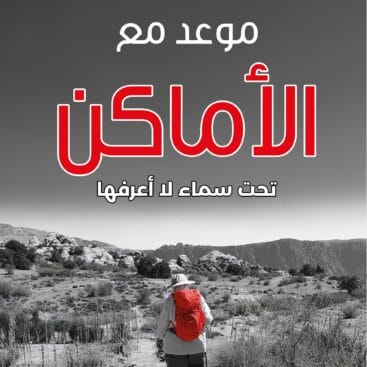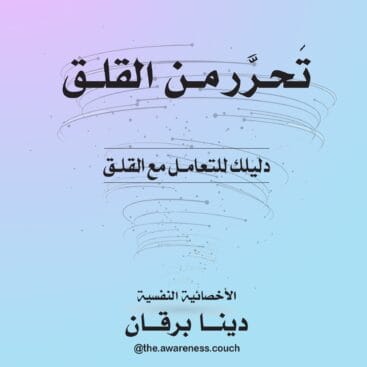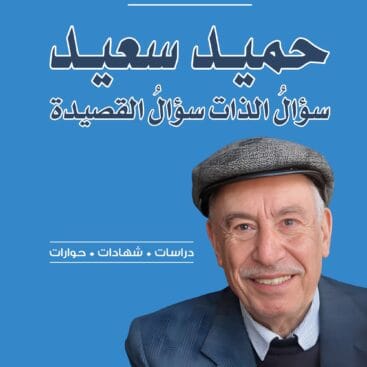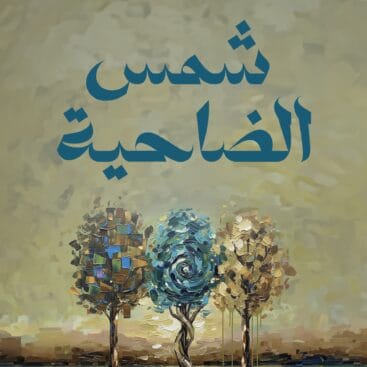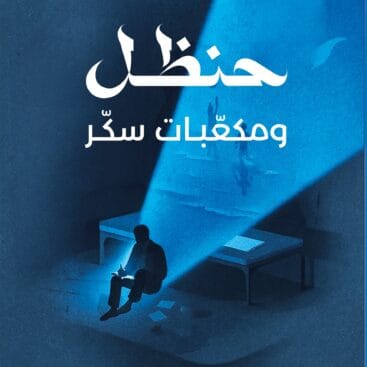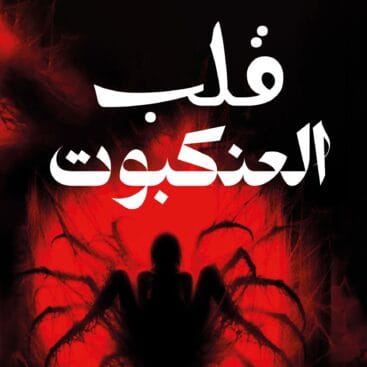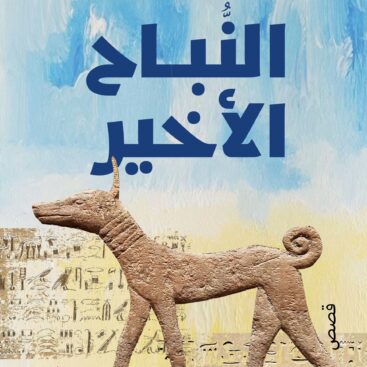مرايا الأرواح.. مغامرة فلسفيّة أمام الأسئلة الكبرى
رمزي ناريتأتي رواية «مرايا الأرواح» للكاتب الأردنيّ جريس سالم بقاعين ضمن ذلك النوع من الأعمال التي لا تُقارب عبر الحكاية وحدها، بل عبر ما تفتحه من أسئلةٍ وما تُثيره من ارتجاجات في الوعي. فمنذ السطور الأولى يتبيّن للقارئ أنه أمام نصّ يبتعد عن الأسلوب السردي المألوف، ويتّجه إلى بناءٍ تأمّلي يضع التجربة الداخلية في مركز الحدث، بحيث يصبح العالم الروائي امتدادًا للحركة النفسية لا العكس. وفي هذا الإطار، لا تقدّم الرواية سردًا يُتابَع بقدر ما تقدّم مسارًا يُعاش، وتفتح فضاءً يتداخل فيه النفسي بالفلسفي، والرمزي بالواقعي، في محاولة لاستعادة العلاقة الأولى بين الإنسان وسؤاله، وبين الذات وظلالها التي ترافقها ولا تفارقها.هذا الاختلاف في آلية التكوين السردي لا ينبع من رغبة في كسر القوالب وحسب، بل من رؤية جمالية تحرص على أن تكون الرحلة الروحية التي يخوضها البطل هي المحرّك الأساسي للنص. لذلك يأتي الخطاب الروائي هادئًا، متأنيًا، يقدّم معانيه ببطءٍ محسوب، ويترك للقارئ فرصة الإصغاء إلى الطبقات العميقة للوجدان الإنساني. ومن هنا يمكن القول إن الرواية تنتمي إلى ذلك النمط من الأعمال التي تخلق قارئها الخاص؛ القارئ الذي لا يبحث عن حدثٍ متتابع بقدر ما يبحث عن معنى ينكشف تدريجيًا، وعن لحظة صدق تتيح له أن يرى نفسه في المرايا التي يضعها النصّ أمامه.بطل الرواية، آريان، لا يُقدَّم ككيانٍ مكتمل،...