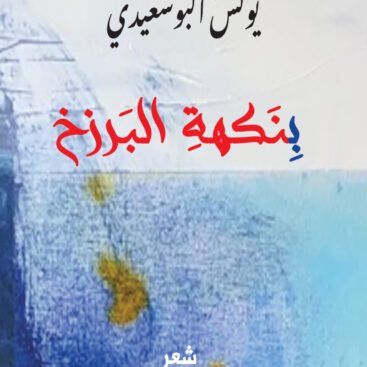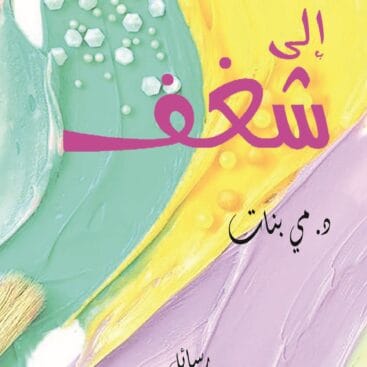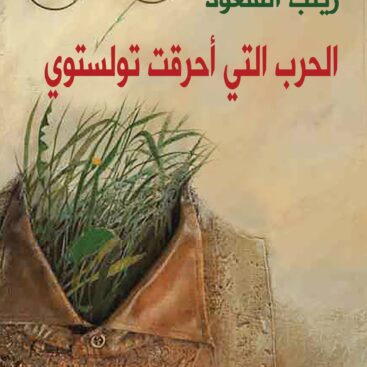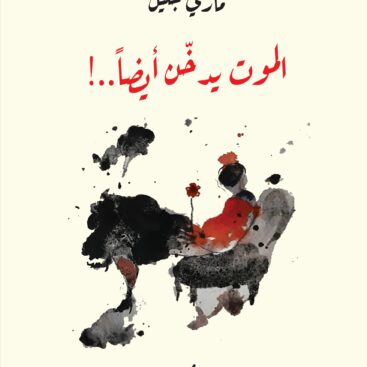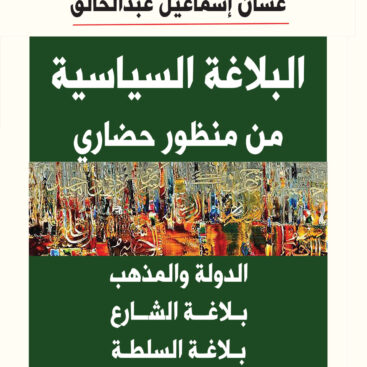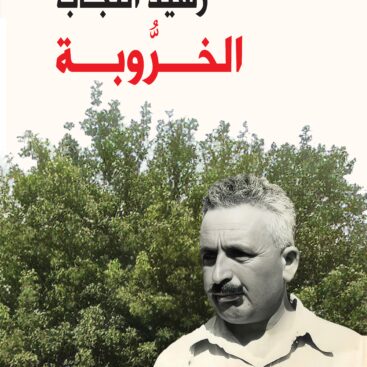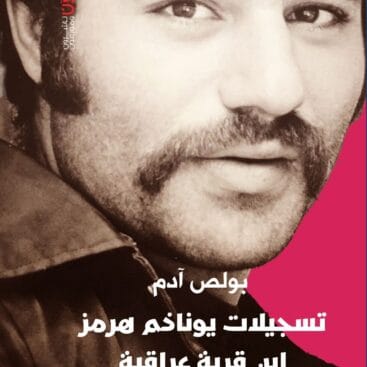قيمة الانتماء في مجموعة “بنكهة البرزخ” للشاعر يونس البوسعيدي
فاطمة حيدر العطاالله -شاعرة وروائية سورية-يُعدُّ الانتماء حالة وجودية عميقة ترتبط بهويته وثقافته وتاريخه. الشاعر يعيش الانتماء كجزء أساسي من تكوينه الإبداعي، حيث يصبح هذا الانتماء مصدر إلهامه وقوة تعبيره. الانتماء أيضًا يخلق لدى الشاعر مسؤولية تجاه مجتمعه، فهو لا يكتب لنفسه فقط، بل يصبح صوتًا يعبر عن آمال وآلام الجماعة التي ينتمي إليها. من خلال شعره، يمكن أن يعبر عن قضايا وطنه، يدافع عن قيمه، أو حتى ينتقد ما يراه معيقًا لتقدمه. هو الجسر الذي يربطه بماضيه وحاضره، وهو البوصلة التي توجه إبداعه نحو المستقبل. يُعدُّ الشاعر صاحب قضية، كما يُعدُّ الثائر بطبيعة الحال؛ فهو يعكس حال وواقع مجتمعه وأمته وظواهر هذا المجتمع وما فيه وما يعاني، وهو بصورة تامّة يرسم بوعيه الجمالي صورة واضحة المعاني الجمال، ويكون ذلك عفواً؛ أي من خلال إيمانه بقضيته التي يتحدث عنها، ولا يلبث الشاعر إلا أن يتبنى من ضمن هذه القيم الجمالية قيمةَ الانتماء؛ فهو لا يغفل عن هذه القيمة لما لها من أثر جمالي يصنع كينونته الشعرية وتفاعله الإنساني مع مجتمعه ووطنه؛ فهو عندما يخلّد هذا الانتماء –ونعني الانتماء الوطني – يعكس صورة جمالية لذاته بوعي مختلف عن القيم الأخرى، ولعلَّ هذه القيمة من أهمّ القيم لما تعنيه في فكر الشاعر وهويته ويمه الأخرى؛ فالشاعر عندما يبرز انتماءه لوطنه، فهو...